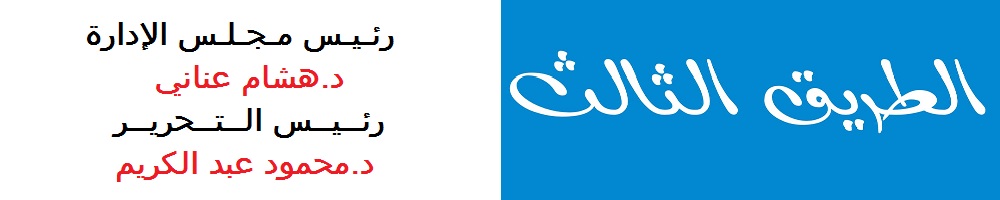أزمة التعليم في مصر .. هل ستجد طوق النجاة؟!
بقلم/ حسين السيد
لاشك في أن مستوى التعليم متردي على أكثر من مستوى في مصر ويواجه بعض التحديات التي تعوق نموه وتؤثر على أدائه وكفاءته، ولم نزعم بأنه يسير فى الاتجاه الصحيح، بل نكون من الضالين إذا زعمنا أنه تعليم مثالى، ويمكن القول ونحن فى قمة الحزن والأسى: لا يوجد تعليم بمصر من الأساس، فبحسب مؤشرات المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2017، احتلت مصر مرتبة متأخرة فيما يتعلق بجودة التعليم الأساسي والعالي، مرتبة أرجعها البعض إلى عدم وضع الحكومات المصرية المتتالية التعليم على سلم أولوياتها لعقود من الزمن. فعلى الدولة أن تعترف وتقر بهذا، لكى تصحح وتعدل من حال التعليم، وتتجه إليه كليةً، ويكون همها الأول هو إصلاح أمره، لأنه ببساطة لا سبيل إلى النهضة التى ننشدها دون الاهتمام بالتعليم.
وأول شىء على الدولة أن تفعله، هو إلغاء الدروس الخصوصية، والتشديد فى هذا الإلغاء، إما عن طريق حبس المعلم أو بإلزامه برد الأموال التى حصَّلها من أولياء الأمور إلى الدولة لتنفق بها على التعليم، والأمر ليس صعبا، فمعاقبة واحد أو اثنين أو حتى مجموعة كفيلة بردع الآخرين، وكذلك معاقبة ولى الأمر بحرمان ابنه من دخول الامتحان إن ذهب إليه المعلم فى بيته، قلنا إن أرادت الدولة إصلاح التعليم فعليها أن تلتفت إليه.
فإذا نظرنا إلى مراكز الدروس الخصوصية (السناتر)، فسنجد مئات من الطلبة، تخرج وتدخل، وكل طالب، أو ولى أمر إن شئنا الدقة، يدفع مبالغ طائلة فى المواد كلها، فلم يعد الأمر يقتصر على مادة واحدة أو اثنتين، وإنما فى جميع المواد، وهو أمر مرهق جدا على رب الأسرة الذى ينفق على ابنه من جميع النواحى، وإذا كان له إخوة، فالأمر فى غاية المشقة عليه، وكان الله فى عونه.
وصار المدرس الواحد يجنى آلافا من الجنيهات فى المجموعة الواحدة، وإذا كانت لديه عدة مجموعات لعدة صفوف دراسية، أدركنا أنه يجنى أرقاما فلكية، وحُق له أن يركب سيارة فاخرة، ويقتنى بيوتا عامرة، ويكون له حراس يحرسونه ويحمونه، كما فعلت المعلمة التى اصطحبت مجموعة من “البودى جاردات”، كما لو أنها وزيرة أو ذات منصب كبير.
ولقد عملت فى بداية حياتى مدرسًا فى مدرسة خاصة بالزمالك، أى من المناطق الراقية جدًا كما نعلم، ووجدت استهانة من التلاميذ بالمواد، فأخبرنى زميل لى أن التلاميذ تعتمد على الدروس الخصوصية الاعتماد الأكبر، وأن المدرسة مجرد روتين يومى يؤدونه، ونصحنى إن كنت أريد الاستمرار بعيدًا عن قريتى أن أنال ثقة التلاميذ، فأدخل بيوتهم وأعطيهم دروسا خصوصية، وقال لى: سيدفع لك كل تلميذ مبلغًا كبيرًا، وذكر لى أنه فى حدود خمسمائة جنيه على مدار الشهر، كان ذلك قبيل ثورة يناير، وما عليك إلا أن تنال الثقة فقط، وعدَّد لى فوائد الدرس الخصوصى، منها واجب الضيافة فى بيوت هؤلاء الأكابر.
ولأنى أومن دائما بالقناعة، وأن البركة فيما رزقنا به الله، أقسمت بينى وبين نفسى على رفض إعطاء درس خصوصى لأى تلميذ، مهما كانت الإغراءات المادية، وإلى الآن أرفض تماما هذه الفكرة مهما ضاقت علىَّ الدنيا، فلا أستطيع أن أتقاضى من تلميذ راتبًا آخر الشهر، فكنت أعتبرها سرقة من جيب الأب، لأننى لا أفكر فى التلميذ قدر تفكيرى فى والده، فكنت أدرك مدى تعب الوالد الشديد ليحصل على عدة جنيهات فى اليوم الواحد إن كان يعمل باليومية، أما لو كان موظفا فراتبه ثابت آخر الشهر لا يزيد، لكن تزيد عليه الأعباء والمسئوليات كل فترة.
إن الأب، أى أب، يحرم نفسه من أمور ضرورية، لكى يلبى طلبات أبنائه، فقد يكون مريضًا لكنه لا يذهب إلى الطبيب لينفق على أبنائه، وغيره وغيره.. هل بعد كل هذا آخذ أموالاً من هذا الأب الكادح، نحن لم نتحدث إلا عن بند واحد وهو التعليم فقط، وهناك أساسيات أخرى تقع على عاتقه من مأكل وملبس ومسكن ..الخ. ولهذا قضيت فى هذه المدرسة واحدا وأربعين يوما فقط، وبعدها طلبت إجازة ولم أعد إليهم مرة أخرى.
أما عن مستوى المدرسين، أو زملائى تحديدًا، فكان فى غاية العجب، كانوا يعطون دروسًا لكنهم لم يفقهوا كثيرًا من المادة، أو أقول فيهم كما قال الدكتور طه حسين فى مدرسى مادة اللغة العربية: “فليس فى مصر أساتذة لهذه اللغة، لا من حيث إنها أداة للتعبير ووسيلة من وسائل البيان.. ليس فى مصر أساتذة للغة العربية وآدابها، وإنما فى مصر أساتذة لهذا الشىء الغريب المشوه الذى يسمونه نحوًا وما هو بالنحو، وصرفًا وما هو بالصرف، وبلاغة وما هو بالبلاغة، وأدبًا وما هو بالأدب، إنما هو كلام مرصوف، ولغو من القول قد ضم بعضه إلى بعض، تُكره الذاكرة على استيعابه فتستوعبه، وقد أقسمت لتقيئنه متى أتيح لها هذا!”.
وذات مرة طلبت مديرة المدرسة من قسم اللغة العربية إعداد موضوع حول فضل اللغة العربية ومكانتها لإلقائه فى حفل ما، واحتار أغلب الأساتذة فى تجهيزه، وطلبوا منى المساعدة، أو الإسهام بنصيب من الموضوع، ولم يحل الإشكال إلا تأجيل المديرة للحفل، ولا أدَّعى أننى كنت أكثر علما منهم، بل كنت أتعلم وقتها، ولم أر فى نفسى يوما ما أننى أصلح للتدريس، لكنى كنت مُلمًا بالقواعد الأساسية من النحو، وبدأت أطور نفسى وأقرأ كثيرًا فى كتب الأدب والنحو واللغة. انتهى بى الحال إلى ترك المدرسة وعدم العودة إلى التدريس نهائيا، فلم يكن الراتب مجزيًا بالمرة، ولم يكن هناك تعيين أيضًا، وبحثت عن وظيفة أخرى.
الأمر الثانى، عودة التلاميذ إلى المدارس، ولا تحدثنى عن كثافة الفصول وازدحامها، ففى مراكز الدروس الخصوصية مئات منهم فى المجموعة الواحدة، ومع ذلك يسيطر المعلم عليهم جميعا، لأنه ببساطة التلميذ هو من يدفع ثمن تعليمه، ومن ثم هو حريص على الإنصات ليتعلم ويستفيد.
الأمر الثالث، تعيين من لم يتعين من المدرسين الذين يعطون دروسا خصوصية، وسد العجز عن طريقهم، كذلك لابد من معرفة السبب وراء إقبال التلاميذ على مدرس بعينه، ومراقبة هذا المدرس، هل يشرح فى المدرسة كما يشرح فى درسه الخاص، ولابد من معاقبة المقصرين منهم.
أيضا، على الوزارة رفع رسوم المدارس، فلتكن ألف جنيه لكل سنة دراسية، فلو كان عدد التلاميذ 17 مليونا فى مصر، فسيكون الناتج 17 مليار جنيه كل عام، وعن طريق هذا المبلغ تُبنى مدارس إضافية، وتُطور المدارس التى تحتاج إلى تطوير، وتُرفع رواتب المدرسين إلى الدرجة التى تجعلهم لا يلجأون إلى إعطاء دروس خصوصية.
ولا يتحدثنَّ أحد أن هذا مبلغ كبير، وأنه يصعب على الأسر الفقيرة دفعه خاصة إن كانت لديهم فى كل مرحلة تلميذ، قلنا لهم إن الأسر الفقيرة قبل الغنية تحرص على ذهاب أطفالهم إلى الحضانة، وتدفع كل شهر مبلغا، وأقل مبلغ ترضى به الحضانة هو 100 جنيه عن الشهر الواحد، فكيف تعجز عن دفع ألف جنيه طوال سنة دراسية كاملة؟! كما أنه يمكن تقسيط هذا المبلغ على أربعة أقساط طوال العام الدراسى، وتحصله الدولة دفعة واحدة من البنوك، لتبنى مدارسها فى فترات الصيف.
كذلك لابد من عودة الكتاب المدرسى كما كان، فالنظام الحالى القائم على التابلت أثبت فشله الذريع، كما أن الدروس الخصوصية تعتمد على الكتاب الخارجى أيضا، فالكتاب لا غنى عنه، فأنا إلى الآن لا أستطيع أن أقرأ كتابًا إلكترونيًا، فلابد لى من الإمساك بالكتاب الورقى إمساكا محكما، كما أن استيعابى أسرع عن طريقه، إضافة إلى ثبات المعلومة إلى أطول فترة، ويمكن تطوير الكتاب المدرسى إلى الطريقة التى تلائم التلميذ، فلا يمكن لى أن أنسى كتب المدرسة وهى توزع علينا عندما كنا تلاميذ، كان لها سحر خاص وبريق يخطف القلوب قبل الأبصار.